بقي الحديث النبوي صافياً لا يعتريه الكذب، ولا يتناوله التحريف والتلفيق طوال اجتماع كلمة الأمة على الخلفاء الأربعة الراشدين، قبل أن تنقسم إلى شيع وأحزاب، وقبل أن يندس في صفوفها أهل المصالح والأهواء، وكانت البادرة الأولى التي ترتبت عليها الاضطرابات الكثيرة في القرن الهجري الأول هي فتنة عثمان- رضي الله عنه- واستشهاده، فقد هزت العالم الإسلامي هزة عظيمة، وأورثت الأمة عواقب وخيمة، امتدت آثارها إلى يومنا، ثم اجتمعت، بعد الفتنة، كلمة المسلمين على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-، إلا أن الأحداث كانت أقوى من أن تفسح للهدوء والسلام سبيلهما إلى الدولة آنذاك، فحصل انقسام كبير في صفوف الأمة، تجسم في معسكر أمير المؤمنين على الذي انطوى تحت جناحه أهل الحجاز والعراق، ومعسكر أمير الشام معاوية الذي انضم إليه أكثر أهلها وأهل مصر.
ويؤكد د. حسن إبراهيم في كتاب «تاريخ الإسلام» أن الوضع ارتبط بشكل أساسي بحدوث الفتن والانقسامات، وجر هذا على الأمة الحروب الطاحنة، وما لبث أن انتهى بالتحكيم الذي كان سبباً لظهور فرق سياسية مختلفة.
الأحزاب والفرق اتخذت شكلاً دينياً كان له أبلغ الأثر في قيام المذاهب الدينية في الإسلام. وحاول كل حزب أن يدعم ما يدّعي بالقرآن والسنة، ومن البديهي ألا يجد كل حزب ما يؤيد دعواه في نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة، فتأول بعضهم القرآن، وفسروا بعض نصوص الحديث بما لا تحتمله، إلا أن هذا لم يحقق ما يرمون إليه، ولم يجد بعضهم إلى تحريف القرآن أو تأويله سبيلاً، لكثرة حفاظه، فتناولوا السنة بالتحريف وزادوا عليها، ووضعوا على رسول الله ما لم يقل.
ونشطت حركة الوضع مع الزمن، حتى اختلط الحديث الصحيح بالموضوع، وظهرت أحاديث موضوعة في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم من رؤساء الفرق وزعماء الأحزاب، ثم ظهرت أحاديث في دعم المذاهب السياسية والفرق الدينية، وكانت الأحاديث الموضوعة تولد مع ظهور الفرق، فينبري من يضع أحاديث تنتقص تلك الفرق، كما يقف الواضعون من الخصوم للدفاع عنها وهكذا، حتى تكونت مجموعة من الأحاديث الموضوعة التي كشف عنها جهابذة هذا العلم ورجاله.
ولم يقتصر الوضع على فضائل الأشخاص، ودعم الآراء والأفكار العقائدية والمذاهب السياسية، بل تعداها إلى مختلف أبواب الحديث، وكادت الأحاديث الموضوعة تتناول جميع جوانب الحياة الخاصة والعامة، فوضعت أحاديث في الفضائل والمثالب، وأحاديث في مناقب البلدان والأيام، وأخرى في العبادات المختلفة والمعاملات والأطعمة والأدب والزهد، والذكر والدعاء، وفي الطب والمرض والفتن والمواريث وغيرها.
هذا الوضع نشأ قبل منتصف القرن الهجري الأول بقليل، وسرعان ما كان يعرف الحديث الموضوع لكثرة الصحابة والتابعين الذين عرفوا الحديث وحفظوه، ولم يؤخذوا بأراجيف الكذابين، وأخبار الوضاعين، هذا إضافة إلى أن أسباب الوضع في ذلك القرن لم تكن كثيرة، وكانت الأحاديث الموضوعة تزداد بازدياد البدع والفتن، وكان الصحابة، وكبار التابعين، وعلماؤهم في معزل عنها.
ويربط تقي الدين أحمد بن تميمة في كتابه «المنتقى من منهاج الاعتدال» بين الوضع والفتن، ويصور لنا ذلك في قوله: والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتناً من سائر من بعدهم، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف، ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج، وبدعة الرافضة، ثم لما كان آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية، ثم لما كان في أول عصر التابعين، في أواخر الخلافة الأموية، حدثت بدعة الجهمية والمشبهة الممثلة، ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك، وكذلك فتن السيف، فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين يغزون العدو، فلما مات معاوية قتل الحسين، وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة، ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط، ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة، ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة، ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة، وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة، ثم لما تولي الحجاج العراق خرج عليه محمد ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية، ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان، وقتل زيد بن علي بالكوفة وقتل خلق كثير آخرون، ثم قتل أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفها.
وعلى هذا، نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة، كما نستبعد تطوع أحد من الصحابة بوضع الحديث على لسان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن يتصور مسلم، الصحابة الأجلاء، الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل الله ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجروا أوطانهم وقاسوا ألوان العذاب، ومرارة العيش استجابة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يعقل أن يتصورهم يفترون ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين نشأوا في رعايته، وتخرجوا في جامعته، ونهلوا من معينه، وتأسّوا بعمله، فكانوا على جانب عظيم من التقى والورع والخشية، لذلك ننفي إقدام الصحابة الكرام على الكذب على رسول الله.
وكما نفينا عن الصحابة انغماسهم في الوضع، ننفي عن كبار التابعين وعلمائهم ذلك أيضاً ونقرر أنه إذا حصل الوضع في النصف الأول من القرن الهجري الأول، فإنما صدر عن بعض المستهترين الجاهلين من طبقة التابعين وأتباع التابعين، الذين حملتهم الخلافات السياسية والأهواء الشخصية على انتحال الكذب، ووضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العصر، عصر التابعين، كان الوضع أقل منه في عصر أتباع التابعين، لكثرة الصحابة والتابعين الذين مارسوا السنة وبينوا القيم من الصحيح، ولعدم تفشي التحلل والكذب في الأمة، لقربها من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا تزال متأثرة بتوجيهاته، محافظة على وصاياه، تعمها التقوى والورع والخشية، كل هذا خفف من انتشار الكذب والوضع، إلى جانب أن دواعي الوضع وأسبابه كانت ضيقة محدودة في نشأتها الأولى، ثم كثرت وازدادت فيما بعد.
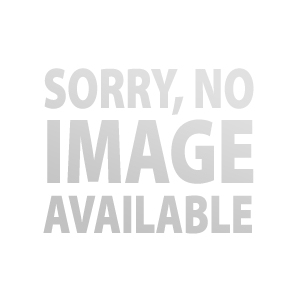


0 تعليق
اتبع التعليمات لاضافة تعليق